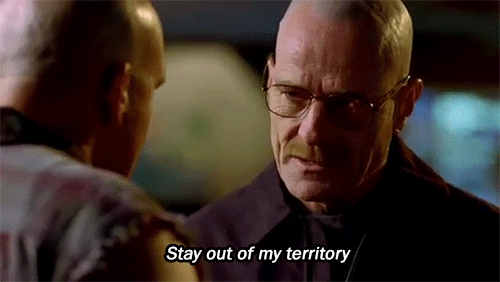في حين تبدو صديقتي مهمومة لأن أحدا لم يجب على اتصالاتها ليشاركها وجبة الغداء، أستمع إلى شكواها بأبعد مسافة انفصال ممكنة عن حالة حرجة كهذه لا أفهمها ؛ أنا التي تسجّل حجزا في مطعم فاخر لتذهب للعشاء بدون أن تفكر في اصطحاب أحد حتى ترى صديقاتي تصوير ذلك ثم يسألنني: منال سلامات؟ فأجيب: اوه ..نسيت! أنا فعلا أنسى أن أدعُ أحدا لأنني لا أشعر بالحاجة لذلك، ذلك لا يجعلني شخصا انطوائيا كئيبا، على العكس؛ أنا الفتاة الأكثر صخبا في الحفلات لكنني لا أجد ضيرا من الذهاب منفردة إلى مقهى أحبه أو حدث ممتع ما. الانفراد ليس مرادفا للوحدة، ذلك ما لا يفهمه أصدقاؤنا المفرطون في اجتماعيّتهم،
في صحّتي ..وصحة آلاف الانطوائيين في مدينة كبيرة، هذه 7 قواعد سرّية للتعامل معنا ولتساعدنا على البقاء معكم لا تخبر أصدقاءك عنها:
1.جاهزون للتبني
الطريقة الأفضل لدينا للتفاعل الاجتماعي هي البقاء بجوار شخص اجتماعي يتبنانا اجتماعيا، يقوم هذا الشخص بالمبادرات اللازمة لإخراجنا من أمام نتفلكس، يمتاز بقدرة على مقاومة الرفض المتكرر والتبريرات السخيفة التي نقدمها عند الاعتذار عن الخروج، عملية التبني هذه عملية في الغالب عبثية، تنتهي دائما بان هذا الشخص الاجتماعي يحضر عشاءه ويجلس أمام نتفلكس معنا، يتحول إلى انطوائي مغلوب على أمره، وهذه مؤامرتنا السرّية للقضاء على الاجتماعيين، لكننا لا نفصح عنها دائما.
2. نستمتع بتدليل النادل لنا
مالا تعرفونه أن نادل المطعم ومديره ومالكه جميعهم يدللون هؤلاء الذين يحضرون للأكل بمفردهم، أحصل دائما على أولوية في الاستجابة للطلب، طبق حلو مجّاني، يدعونك أحيانا لتجربة طبق جديد أو مشروب جديد يخططون لإضافته إلى القائمة، أنت بنظرهم عنصر متفرغ ويجب إشغاله وترفيهه حتى لو كان أمامك لابتوب وتشاهد مسلسلا أو تقرأ كتابا، إنهم يتصرّفون تجاهنا بحنّية وشعور بالخجل ويبدون في حالة اعتذار دائمة لكوننا منفردين، هذا رائع جدا أنا أحصل على كوبونات خصم لشخصين حتى يشجعوني على الحضور برفقة أحد ما، ما أفعله هو أنني أحضر مرتين مجانا … فزت! باختصار عندما تخرج منفردا تحصل على خدمات إضافية، وتدفع أقل، في الحياة أمور امتيازية مثل الكود الخفي في اللعبة لا يمكنك اكتشاف ميزاتها إذا كنت تلعب دائما نفس المرحلة بنفس الطريقة.
3. تعال مع خطة
ضربتين في الراس توجع، في حال قرر المتبني اصطحابنا فيكفي أننا سنقرر الخروج، ديل؟ لا تطالبنا بخطة، رجاء، الأمر الجيد أننا لسنا متطلبين، مهما كانت خطتك رديئة فهي جيدة كفاية لنا، على العكس لا نفضل الخطط ذات الفعاليات الكثيرة، لأنها ستتطلب منا جهدا إضافيا للتواصل، وهذا كثير في يوم واحد، إذا كانت خططك للخروج من هذا النوع فعليك أن تقسّمها لنا على دفعات، على أيام.. على أسابيع
4. اقبل خطتنا البسيطة
عندما نتجاوب معك، قد تشعر – لا سمح الله – أن لدينا خطة مجدولة تستحق الحماسة، لا … نعلب بلايستشن، نمشي في طريق ما، نصنع عشاء منزليا.. ندردش.. هذه الخطة الرائعة لا يمكن أن نتوقف عن التحمس لها باستمرار، هديء من روع توقّعاتك الاجتماعية بشأننا.
5. احضر سوالفك معك
أقول هذا دائما لأصدقائي (تعالوا مع سوالفكم) .. الانطوائيون مستمعون بامتياز، سأحب أيّ (سالفة) تقولها مادمت أحبك، تريد الحديث عن ضربات الجزاء الضائعة في الدوري؟.. لا مشكلة
6. الصمت مسكين..أحبّوه
في حال لم تكن سوالفك متوائمة مع وقت لقائنا، ستتعرف على صمتنا، قد تعتقد أننا نشعر بالملل، لا .. أؤكد لك نحن نتحدث كثيرا داخل رأسنا، أحاديث لا تقل عن سوالفك متعة وربما أكثر (نو أوفنس) ، هذا هو الوقت المناسب لتقلّب جوالك، تتشاجر مع الخلق في تويتر، تلعب ببجي، خذ راحتك.
7. لا تعيدها …
نكون في أمان الله معك، تأتيك فكرة شيطانية في دعوة
شخص إضافي يتناقض مع طبيعتنا، على الأغلب يكون شخصا ثرثارا يبالغ في التعرّف علينا،
ولديه تلك الديناميكية في تسجيل أرقام جوالات كل الذي يلتقيهم، دمّه ثقيل، ولم
يشاهد Friends في حياته… النصيحة المتعلقة بهذه النقطة هي: لا تعيدها.